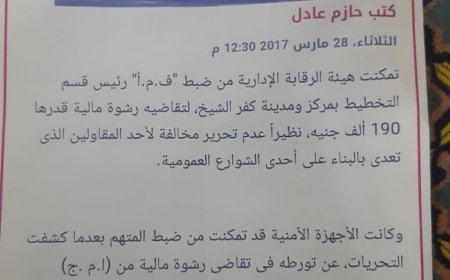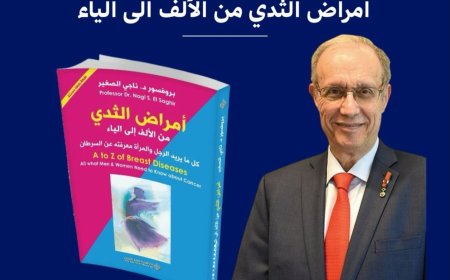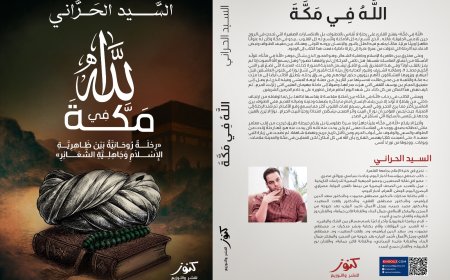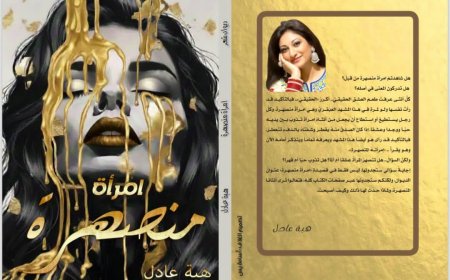السفير الدكتور عادل عيد يوسف يكتب: مافيا الآثار كيف تُنهب حضارة وتُباع في المزادات؟

في أعماق الأرض المصرية، حيث ينام التاريخ تحت طبقات من الزمن، تتنفس الحضارة من كل ذرة تراب، وتنتصب الآثار كأعمدة شاهدة على أمجاد لا تنطفئ. هنا، في هذا المدى المجبول بالخلود، لا تزال الكنوز مدفونة، تحرسها الرمال وتصونها الأساطير. كنوز لا تطلب شيئًا سوى أن تُكتشف بشرف، وأن تُنقل إلى الضوء بكرامة، لتروي حكاية شعب كان يومًا سادة الدنيا.
لكن في جنح الليل، حين يخفت صوت الضمير وتعلو همسات الطمع، تمتد الأيدي الخائنة لتنهب من جوف الأرض ما لا يقدَّر بثمن. تُنتزع القطع الأثرية كما تُنتزع الأرواح، وتُهرب خارج الوطن كما تُهرب الخيانة. هناك، في صالات المزادات الغربية، تُعرض كنوزنا كأنها بلا ماضٍ، بلا نسب، بلا هوية. قطعة بعد أخرى، يتسرب التاريخ من بين أيدينا، وتتلاشى خيوط الحضارة في صمت موجع.

ليست هذه مجرد جرائم فردية، بل جزء من منظومة سوداء تدرّ سنويًا نحو 20 مليار دولار، ما يجعل تجارة الآثار ثالث أكبر تجارة غير شرعية في العالم بعد السلاح والمخدرات. لكن الخسارة لا تقاس فقط بالدولار، بل بما هو أثمن: الهوية، والانتماء، وروح الحضارة ذاتها. فالأمة التي تُسرق آثارها، يُنتزع منها تاريخها، وتُكتب حكايتها بأقلام الآخرين.
ما يحدث في بعض المناطق الأثرية المنسية هو أقرب إلى الجريمة المنظمة. تُنقب القبور بالأيادي المرتعشة المهووسة بالدجل، حيث تُستحضر طقوس “الرصد” و”الجن” و”الزئبق الأحمر”، ويُعامل التاريخ وكأنه كنزٌ سحري مدفون، لا رسالة حضارية يجب حمايتها. ولأن الجريمة حين لا تُواجه بالعقاب الصارم تتحول إلى عادة، صار بعضهم يعلن عن مقابر مكتشفة عبر مجموعات “واتساب”، أو على صفحات فيسبوك، بكل بجاحة، وكأنهم يروجون لعقار أو قطعة أرض، لا كنز أثري من روح الأمة!
في واقعة صادمة، كُشف عن تهريب تسعة آلاف قطعة أثرية من منطقة عين شمس وحدها. الرقم وحده كافٍ ليهز ضمير وطن، ويُعلن أن ما يحدث ليس مجرد جريمة، بل خيانة موصوفة. فمن يفرّط في آثار بلاده، كمن يبيع دماء أجداده، ويقايض هوية شعبه بثمن بخس. ردًا على هذا النزيف، أقرّ البرلمان المصري تعديلات على قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، رافعًا العقوبات إلى السجن المؤبد وغرامات تصل إلى 10 ملايين جنيه، مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة. ورغم صرامة النص، لا تزال فعالية التنفيذ تواجه تحديات حقيقية في المناطق النائية، حيث القانون غائب، والرقابة نائمة، والثغرات واسعة كقلب خائن.
المأساة لا تقف عند حدود الجريمة المادية، بل تتعداها إلى استغلال سياسي خطير. تُعرض بعض القطع المسروقة في متاحف العالم داخل سياقات تُعزّز مركزية الغرب، وتُقصي العرب والمصريين من سجل الحضارة. التمثال يُعرض، والقصة تُعاد كتابتها، واسم مصر يُطمس، ليُقال إن الإنجاز “إرث إنساني عام” بلا جذر ولا سياق.
من يسرق تمثالًا لا يسرق حجرًا، بل يسرق فصلًا من كتاب الوطن. ومن يهرب قطعة أثرية، لا يهرب كنزًا، بل يُهرّب شيفرة هوية. فالمخدّرات تدمّر الأجساد، أما الآثار فتدمّر الروح الوطنية. والجاسوس يسرّب معلومة، أما هذا، فيسرّب جوهر الأمة. لا بد أن يُعامَل هؤلاء كخونة، لا كمجرمين عاديين. لأنهم لا يبيعون شيئًا قابلاً للتعويض، بل يبيعون ما لا يُقدّر بثمن: التاريخ، الكرامة، والانتماء.
المعركة ضد مافيا الآثار ليست قانونية فقط، بل ثقافية أولًا. علينا أن نُعلّم الطفل في مدرسته أن هذا التمثال ليس حجرًا، بل قصة، وأن هذه المقبرة ليست كهفًا، بل حضارة. يجب أن تتضافر جهود الدولة والمجتمع، وأن تُدعم الأجهزة الأمنية بتقنيات حديثة، وخبرات عالمية.
وفي الميدان العالمي، تخوض الإدارة العامة للآثار المستردة معارك قانونية شرسة، ونجحت في استعادة قطع نادرة من دول مثل فرنسا، منها تماثيل لأمنحتب الثالث وحورس وآثار تعود لعصور مختلفة، في رحلة استعادة الكرامة.
إن السكوت على تهريب الآثار ليس تفريطًا في حجر، بل في حضارة وهوية وأمن وطن. ولا مستقبل لأمة تُباع ذاكرتها في المزاد، ويُروى تاريخها بلسان الغير. من لا يحترم ماضيه، لا يحق له أن يحلم بمستقبل. فليكن صوت الوطن أعلى من صوت السوق، ولتكن صرخة الضمير أقوى من صفقة المليار.