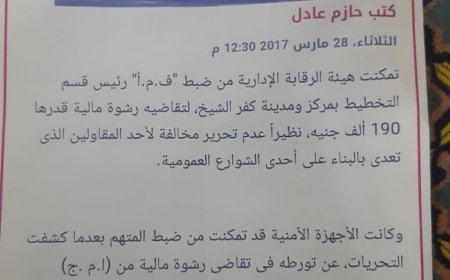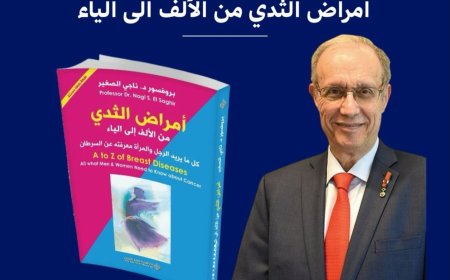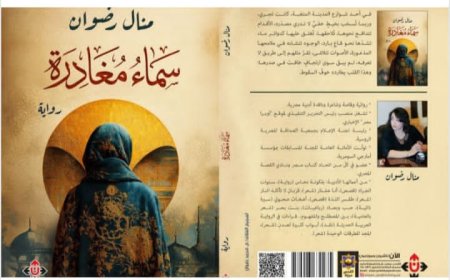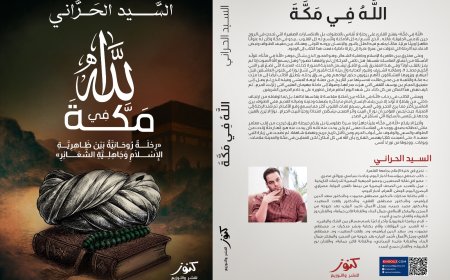مصطفى صلاح يكتب: حارس الصدق وجراح الأحاسيس.. محمد عبد العزيز وصناعة اللحظات الخالدة

محمد عبد العزيز... اسم لا يُذكر إلا ويقف أمامه الفن إجلالاً، وتصمت أمامه الكلمات قليلاً، كأنها تخشى أن تقصر عن وصف رجلٍ لم يكن مجرد مخرجٍ، بل كان حارسًا على جمال الروح في زمنٍ بدأت فيه المعاني تبدّل وجوهها. محمد عبد العزيز، الذي لم يسعَ إلى الأضواء، بل آثر أن يظلّ خلف الكاميرا كراهبٍ في محراب السينما، يُنصت للنبض، ويتقصى الدفء في زوايا الحكايات.
كان يعلم أن السينما لا تُصنع بعدسات الكاميرا وحدها، بل تُصنع بالقلب والبصيرة، وأن الفن لا يسكن في الأطر الزائفة، بل في المواقف التي تهزّ الوجدان وتُصوّب البوصلة. لم ينظر إلى الحياة من برجٍ منعزلٍ، بل اقترب منها، عاش تفاصيلها، وغاص في عمقها، وخرج منها بعيونٍ تعرف الحقيقة، وذوقٍ يُحسن ترتيبها في مشهد.
محمد عبد العزيز من القلائل الذين حملوا مشعل الصدق الفني في عصورٍ بدأ فيها النور يبهت ويُستبدل بالبريق الزائف. لم يكن من أولئك الذين يُجرّبون على وعي الناس، بل من الذين يحترمون وجدان الجمهور ويُعاملونه بضمير الفنان الحقيقي. كان يؤمن أن كل مشهد يُصوّره قد يبقى في الذاكرة، وكل جملةٍ تُقال ربما تُصبح وجعًا أو عزاءً أو سؤالًا، ولذلك كان دقيقًا كأنما يخطّ وصيّته.
من أجمل أعماله التي حفرت حضورها في ذاكرتنا ووجداننا فيلم "الجلسة سرية"... كم من الدموع انسكبت في صمت تلك المشاهد، وكم من ألمٍ انسرب إلى الأرواح دون أن ندرك إلا حين أُطفئت الشاشة وبقي الحزن مشتعلاً في القلب! لم يكن الفيلم حكايةً عن قضيةٍ فحسب، بل مرآةً لحالة إنسانية كاملة، رأينا فيها الحب حين ينكسر، والضمير حين يحتار، والمجتمع حين يتحوّل إلى قاضٍ لا يُجيد الرحمة. كان محمد عبد العزيز هناك، خلف كل زاوية، يرسم التوتر بنظرة، ويُمرر وجع القلب في التفاتة، ويترك الكاميرا تنسج الشعر من مأساةٍ لا تُقال.
محمد عبد العزيز لم يكن مجرد مخرجٍ يتقن أدواته، بل صانع أرواحٍ للشخصيات، ناسجًا دقيقًا لمشاعرهم، حتى كدنا نظن أن تلك الوجوه على الشاشة تعرفنا كما نعرفها. لم يكن يفرض الجمال على الكادر، بل يُخرجه من داخله. يعرف متى تصمت الكاميرا، ومتى تتكلم، متى تراقب، ومتى تحتضن.
هو من أولئك الفنانين الذين يُشبهون النبض، لا يُرى ولكن يُحسّ، ومن أولئك الذين كلما مرّ الزمن، ازداد أثرهم عمقًا. محمد عبد العزيز لا يُقارن، لأنه لم يدخل مضمار السباق أصلًا. كان في دربٍ وحده، دربٍ يخصه، تُظلّله القيم، وتُمهّده الحكمة، وتحفّه الرؤية العميقة.
هو صاحب المدرسة التي لا تُشبه سواها، مدرسة تمزج ما بين البساطة والدهشة، الصدق والرؤية، وتُربّي الذائقة من دون أن تُلقي دروسًا. أعماله شاهدة على عصرٍ كان فيه للفن طُهر، وللدراما كرامة، وللمخرج رسالة.
ولأنه كذلك، فإن كل فيلم وقّعه كان بمثابة عُشبة شفاء في أرضٍ مُتعبة. لا تكرار، لا استسهال، لا خضوع للموجة، بل صلابة ناعمة، وشغف نقيّ، وكأن كل عملٍ هو المرة الأولى، والمرة الأخيرة.
الحديث عن محمد عبد العزيز ليس استدعاءً للذكرى، بل اعترافٌ بقيمة لم يغيّرها الزمن، وتقديرٌ لمبدعٍ لا يُعادله أحد. هو في قلوبنا مخرجُ اللحظات الصادقة، وراوي القصص الإنسانية كما يجب أن تُروى.
من عرف محمد عبد العزيز، عرف المعنى الحقيقي لأن يكون الفن موقفًا. ومن تابع أعماله، أدرك أن السينما قد تُبكي وتُفكر وتُطهّر، إن أُعطيت لمن يُجيد حملها.
ولأننا نكتب عنه، فنحن لا نُحييه بكلماتنا، بل نُحيا بفنه. هو ليس فقط مخرجًا أحببناه، بل معلمًا خفيًا لكل من أراد أن يصنع فيلمًا بروحٍ حقيقية. محمد عبد العزيز... هو الصدق حين صار صورة، والنبض حين صار مشهدًا، والإحساس حين صار حكاية.
الفن النظيف يعرف اسمه. والكاميرا، لو نطقت، لقالت: هنا مرّ مخرجٌ يعرف متى يهمس الضوء في العيون.
محمد عبد العزيز لم يكن من أولئك الذين يختبئون خلف زينة الصورة أو بهرجة التقنية، بل كان مخرجًا ينهل من الحياة مباشرة، يلتقط التفاصيل الصغيرة التي تمرُّ علينا دون أن نلحظها، ويُعيد تشكيلها في مشهدٍ يلامس القلب، ويوقظ الذكرى، ويزرع فينا شيئًا لا ننساه. كانت مشاهد أفلامه كأنها وجوه نعرفها، أماكن عشنا فيها، وأصواتًا سمعناها في لحظةٍ ما من عمرنا.
في أعماله، لا تصادف الافتعال ولا تستشعر التصنّع. كل شيء يتقدّم نحوك على مهلٍ، بكامل إنسانيته، لتشعر أنك لا تشاهد فيلمًا، بل تعيش حياةً أخرى. يُحسن الإصغاء للممثل كما يُحسن قيادة روحه، لا يصرخ في وجه الموهبة، بل يربّت على كتفها، ويفتح لها الأفق كي تُحلّق. وهو بذلك لا يصنع فقط مشهدًا، بل يصنع لحظةً من الصدق قلّ أن تتكرر.
إنه من القلائل الذين تخلّى عنهم الإعلام أحيانًا، لكن لم يتخلَّ عنهم الوجدان. لم يكن له صخب يُرافق اسمه، بل سكينة مهيبة، كأن اسمه يُقال همسًا احترامًا لا خفوتًا. كأنه البوصلة التي لا يراها المبحرون، لكنها ترشدهم خفيةً وسط ضجيج البحر. لم يكن يلهث خلف موجة، بل كان يُمسك بيده نهر الزمن، يُبطئه، يُعيد ترتيب نبضه، ويضع عليه عينه وقلبه، ثم يخرج لنا مشهدًا يقول أكثر مما تُجيده الحوارات.
يقولون إن الزمن لا يُنصف الفنان الحقيقي في حينه، وإن العيون لا تبصر من يزرع الجمال خلسةً في أرضٍ مُتعبة. لكنّ محمد عبد العزيز لم يكن ينتظر إنصاف الزمن، لأنه ببساطة، كان أكبر من الانتظار. لم يكن يبحث عن المجد، بل عن الحقيقة. لم يكن يعنيه أن يصفّق الناس بعد العرض، بل أن يصمتوا من التأثُّر، أن يبكوا من دون أن يفهموا تمامًا لماذا، أن يشعروا بشيءٍ نقيّ، يتسلّل إليهم كما يتسلّل ضوء الفجر إلى نافذةٍ منسية.
أفلامه، في عمقها، كانت صلاةً فنية. مشهد في فيلمه قد يغنيك عن عشرات الحكايات، وكلمة تُقال بصوت خافت قد تحمل وجع أجيال. هذا هو الفن حين يُمسكه عاشق حقيقي، يعرف متى يُحب، ومتى يتألم، ومتى يصمت. محمد عبد العزيز لم يكن يحكي عن الناس، بل عن الإنسان، كما هو، بلا مساحيق ولا أقنعة. وكان يُجيد أن يُخرج من كل ممثل أعذب ما فيه، ليس بسلطة، بل بحنانٍ هادئٍ، ورؤيةٍ تخترق القشرة إلى اللبّ.
وإذا كان لكل مخرج لحنه، فإن لحن محمد عبد العزيز كان من تلك الألحان التي لا تُعزف على آلة، بل تُعزف على النفس. مرهف، نقي، حزين أحيانًا، لكنه حزنٌ يطهّر، لا يُدمّر. يُمكنك أن تستشعر حزنه الإنساني في صمت مشهد، أو في زاوية كاميرا تُراقب من بعيد، أو في نهايةٍ لا تُغلق الدائرة بل تتركك معها، تفكّر، تتألم، وربما تُعيد اكتشاف نفسك.
ما يميز محمد عبد العزيز ليس فقط حسّه الإنساني العالي، بل ثقته بالفن كقيمة. لم يُسلّم ذوقه أبدًا للتساهل، ولم يساوم على روحه، حتى حين تغيّرت الأذواق، وانطفأت كثير من القيم. ظلّ كما هو، شامخًا بأخلاقه، متواضعًا بموهبته، واثقًا أن العمل الصادق يترك أثره، ولو بعد حين.
إننا لا نكتب عن محمد عبد العزيز اليوم لأن الزمن أنصفه، بل لأننا نحن من نحتاج أن نُعيد التذكير بأن للفن ضوءًا لا يخبو، وأن بيننا من يليق بهم الاحتفاء الحقيقي لا المُزيّف. هو من أولئك الذين يُحبّهم الفن نفسه، لأنهم حافظوا عليه في زمنٍ كثرت فيه الخيانات.
ولذلك، فإن محمد عبد العزيز لا يُقاس بعدد الأفلام، بل بما تركته تلك الأفلام فينا. لا يُكرّم بالجوائز، بل بالعَبَرات الصامتة التي سقطت أمام مشهده، وبالأثر الباقي في نفوسنا إلى اليوم. هو دليلنا إلى ما يجب أن يكون عليه الفن: صادقًا، نبيلاً، إنسانيًا، ومتوهّجًا ببساطته العميقة.
هذا هو محمد عبد العزيز، مخرجٌ لا يُشبه سواه، ومبدعٌ لا نُشبه أنفسنا إلا حين نُشيد به.