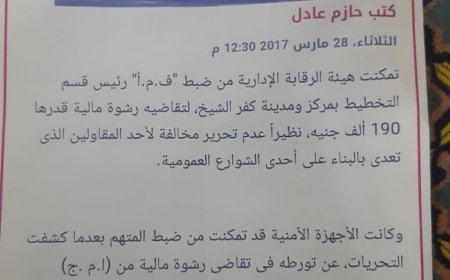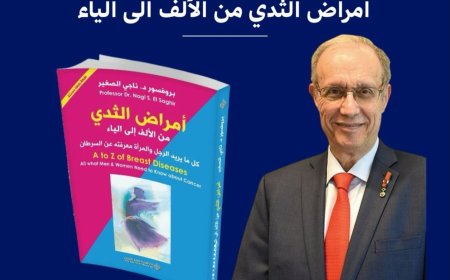مصطفى صلاح يكتب: جمال الغيطاني.. «لو أنك يا حبيبي موجود»

لو أنك يا حبيبي موجود، لقلت لك إنني ما زلت على العهد، أقلبُ الصفحات التي حملت عطرك وعبير فكرك، وأعيد قراءة الكلمات التي نُقشت بماءِ القلب لا بحبر القلم، وأجلسُ بين السطور كأنني أجلس إليك، أستعيد وهج العشرة ووهج الكلمة ووهج الروح.
في شتاء عام 1992، كنت شابًا تتقاذفه الحياة دون بوصلة، بلا شغفٍ يُمسك بتلابيبه، أركنُ إلى الهامش كما يركن الغريب في زوايا المدن التي لا يعرفها. لم أكن من رواد القراءة، ولا من عشاق الورق الصامت المتكلّم، كنت أراها ترفًا لا وقت له، وسفرًا لا أمتلك تذكرة عبوره. حتى جاءني جمال الغيطاني... لا ككاتبٍ وحسب، بل كأبٍ روحي، كمن يشعل في القلب قنديلًا لا ينطفئ.
كان لقاؤنا الأول في ندوة شتوية دافئة رغم برودة القاهرة حينها، يومها كان صوته أكثر حرارة من المدفأة، وكانت كلماته تحمل دفء المعنى وصفاء الرؤية. قدّمني إلى عالمه كما يُقدَّم طفلٌ على عتبة المعبد، دون تكلف، دون منّ، بل بحنو المعلّم حين يرى في تلميذه ملامحًا من ذاته.
أهداني يومها مجموعة من كتبه، كما أهداني مؤلفات ليوسف القعيد ونجيب محفوظ، وضعها بين يديّ كمن يضع مصابيح على دربٍ معتم، وقال لي بصوته الذي لا يزال يرن في أذني: "اقرأ... الكلمات لا تُنسى، حتى إن نُسيت".
لكني – يا حبيبي يا جمال – لم أكن أهلاً لذلك النور حينها، فركنت الكتب على رفّ النسيان، وواصلت الحياة كما كنت: بلا شغف، بلا عمق، بلا سؤال. حتى جاء عام 2002، حين انطفأت أشياء كثيرة داخلي، وفتّشت عن ضوءٍ فلم أجد سوى ذلك الرفّ، وفتحت الكتب، فإذا بي أفتح قلبي على اتساعه.
كانت البداية مع الزيني بركات، تلك الرواية التي شقّتني نصفين، نصف لا يزال يئن تحت سلطة القهر، ونصف يحلم بالعدل المستحيل. قرأتها كمن يقرأ تاريخ نفسه، لا تاريخ المماليك، وشعرت أنني وجدت صوتي بين صفحاتها، وكأنني لم أكن أعرف اللغة حتى نطقت بها على يد الغيطاني.
ثم جاء هاتف المغيب، وكانت دهشتي الكبرى، لأنك – يا جمال – لم تكن تكتب الرواية، بل كنت تكتب الروح، وكأنك تمدّ حبلًا بين الأرض والسماء، وتدعونا لنمشي عليه. كلماتك لم تكن تُقرأ، بل تُحسّ، تُشمّ، تُبكَى. وحين انتهيت منها، لم أكن ذات الشخص الذي بدأها.
ومضيت أقرأ مرافقة البلبل في القفص لـ يوسف القعيد، فوجدت في حكاياه طين هذا الوطن، ورائحته، وجوعه، وضحكته المشروخة. ثم تسلقت الجبل مع نجيب محفوظ، عبر أولاد حارتنا، واستغرقت ستة أشهر حتى أتممتها، لا لأنّها ثقيلة، بل لأنّها كانت تخاطب عُمقًا لم أكن أعرفه في نفسي. كنت أقرأ وأتلعثم، أقرأ وأتعثّر، لكنها كانت الرحلة الأجمل، لأنني – حين أنهيتها – كنت قد وُلدت من جديد.
كنت أحضر ندوات نادي القصة بعدها كمن يعتكف في محراب الفكر،، لا تغيب صورته عن مخيلتي هناك: صامتًا في لحظة، متكلمًا كأن الحكمة تنساب من بين شفتيك في لحظة، حين يتحدث كان الحضور يصغي لا بأذنه فقط، بل بكامل كيانه، لأن بلاغته لم تكن في فصاحة اللغة وحدها، بل في صدق النية، وصفاء القلب، ونُبل المقصد.
كان الغيطاني يكتب كما لو كان ينقش على ضريح الزمن، يفتّش في طبقات الذاكرة المصرية، في ثنايا التاريخ المطمور، ليقول لنا إننا لسنا أبناء اللحظة العابرة، بل أبناء مجدٍ غُفل اسمه. كان كل نصٍّ له يحمل صرخة: لا تنسوا، لا تبيعوا، لا تتخلوا.
يا جمال، لم تكن مجرد كاتبٍ يُمسك القلم ويصوغ الحكايات، بل كنت نَفَسَ وطنٍ يتردد في أوردة الكلمات، وكنت ذاكرةً تمشي على قدمين، تحفظُ لمصر سرها المطمور في الطين، وتبوح بما لا يجرؤ الزمن على نسيانه. كنت تكتب لا لتؤرّخ، بل لتوقظ، لا لتسرد، بل لتفسّر ألغاز الهوية المتراكمة في المآذن، في الأسواق، في الحارات القديمة، وفي عيون الناس. كنت تُمسك بالقلم كما يُمسك الصوفي بسبحته، تُسبّح بحروف الوطن، وترتل نشيد الحكمة من قلب المعاناة. لم تكن تكتب عن مصر فحسب، بل كنت تُنطق مصر نفسها، كما لو أن حروفك أوتارها الخفية.
منك تعلمت أن الكلمة وطن، وأن الكتابة ليست مهنة، بل عهد. منك فهمت أن اللغة لا تكون جميلة إلا إذا حملت قلق صاحبها، وغربته، وحلمه. منك تعلّمت أن الإنسان يمكن أن يعيش أكثر من حياة، إذا أخلص للكتابة كما أخلصت.
وها أنا اليوم أكتب عنك، وأنت غائب بالجسد، حاضر بالروح، أكتب لأنني مدين لك بكل ما أصبحت، لأنك أخرجتني من العتمة إلى الضوء، من السطح إلى العمق، من الخواء إلى الامتلاء.
لو أنك يا حبيبي موجود... لشكرتك. لاحتضنتك. لقرأت عليك ما كتبت. لكنك – كما علمتني – لا ترحل. أنت في كل كتاب أمسكه، في كل فكرة أتشبث بها، في كل وهجٍ أشعر به حين أكتب.
سلامٌ عليك، يا أستاذي ومعلمي وصديقي، يا من علمتني كيف أكون.