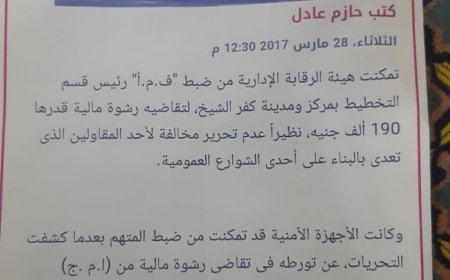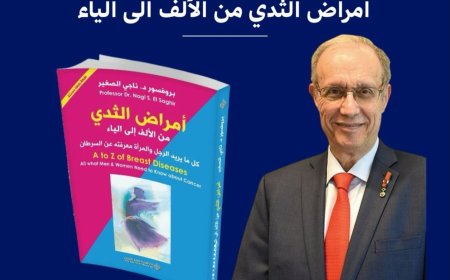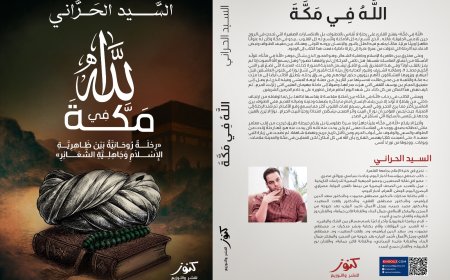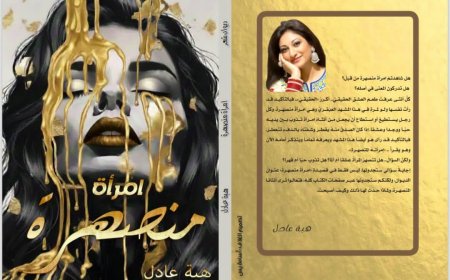مصطفى صلاح يكتب: رحل محمود وبقيت بوسي وحدها..والناس شهدوا.. فهل يكتب الأزهر الكلمة الأخيرة؟

حين تضيق المسافات بين الحقيقة والوجدان، وتُصبح الأوراق أضعف من أن تحكي ما في القلوب، تبرز الحاجة إلى صوت العدالة التي لا تحكمها الأقلام وحدها، بل تصوغها النية، وتبنيها الرحمة، وتُتممها الشريعة. في هذا السياق، تأخذ قضية الإعلامية بوسي شلبي وما يُثار حول علاقتها بالراحل الكبير محمود عبد العزيز طابعًا خاصًا، يمسّ القيم قبل الأشخاص، ويمتد أثره إلى صورة مجتمع لا يزال يُقدّس روابط الحب والوفاء.
لقد عاشت بوسي شلبي إلى جوار الفنان الراحل سنواتٍ طوال، لم تكن فيها مجرد رفيقة درب، بل كانت زوجةً يعرفها الناس، ويشهد بها الوسط الفني، وتؤكدها اللقاءات والصور والمناسبات العامة. لم يكن حبهما مستترًا، ولا حياتهما المشتركة خفية عن أعين الناس، بل كانت حياتهما معلنة، يُباركها الجمهور، ويشهد بها الأصدقاء والزملاء، حتى باتت صورتها إلى جواره جزءًا من حضوره الفني والإنساني.
وإن كان القانون يُعلي من شأن التوثيق، فإنّ الشرع يُقيم الزواج على أركانه الأساسية: الإيجاب والقبول، والشهود، والإشهار، والنية الصادقة للعيش المشترك. وكل تلك الأركان كانت ظاهرة في علاقة الفنان الراحل بزوجته بوسي شلبي. فهل يُعقل بعد كل هذا أن تُنفى العلاقة لمجرد غياب ورقة؟ وهل أصبحت الأوراق أقوى من العشرة، والعيش، والشهادة؟
نحن لا نعلّق على أحكام القضاء، ولا نتجاوزها، بل نكنّ لها كامل الاحترام والتقدير، ونعلم أن للقانون مجراه، وللقضاة ضمائرهم النزيهة. غير أننا حين نستحضر الشرعية كمرجعية، فإننا لا ننتقص من سلطة القانون، بل نبحث عمّا يُكمل الصورة، ويوضح ما قد يخفى، لا سيما حين يتعلق الأمر بحياة إنسانية كاملة، وبيت قائم، وذكرى ممتدة حتى بعد الوفاة.
الناس كانوا شهودًا على هذا الرباط، بأعينهم وقلوبهم، وما من أحد يمكنه إنكار العلاقة التي جمعت بين الفنان الكبير محمود عبد العزيز وبوسي شلبي، لا من حيث المعاشرة، ولا من حيث الاحترام المتبادل، ولا من حيث التصرفات التي لا يفعلها رجل مع امرأة إلا إذا كانت زوجته بحق. ولعل دموع بوسي شلبي بعد رحيله، وتمسّكها بصورته، ووفاؤها لذكراه، كانت من أبلغ الشهادات على عمق هذه العلاقة، وإنسانيتها.
لقد تحوّلت القضية إلى مساحة مؤلمة من التجريح، والتشكيك، والاتهام، وهو أمر لا يليق بمقام الراحل، ولا يليق بامرأة لم تُظهر إلا الحزن والمحبة. وهل تُجازى على وفائها بالتنكر؟ وهل يُكافأ الحزن بالتشكيك؟ إن من أقسى ما يُصيب مجتمعًا أن يجعل من القلوب المحكمة، ومن المشاعر ساحة اتهام.
ومن هنا، تبرز الحاجة المُلحّة إلى كلمةٍ فاصلة من الأزهر الشريف، الجهة التي يُعوّل عليها المصريون حين يلتبس عليهم الأمر، وتتشابك القوانين مع مقاصد الشريعة. إنّ الأزهر بما له من مكانة راسخة، وقوة بيان، هو القادر على أن يقول الكلمة الفاصلة، وأن يُنهي الجدل الدائر حول هذه العلاقة بما يرضي الضمير والدين.
لسنا في موقع الهجوم أو الدفاع، ولسنا في صدد كسب معركة رأي عام، بل نناشد فقط ردّ الاعتبار إلى الحب، وإلى الحق الذي ربما لم تحسن الأوراق تسجيله، لكنه وُثّق في القلوب، وفي الذاكرة، وفي ضمائر من عرفوا الرجل والمرأة، وعاشوا فصولًا من تلك العلاقة الصادقة.
وإذا كانت نوايا الزواج متوفرة، والمعايشة حقيقية، والإشهار واقع، والشهود كُثر، فأيّ معنى يمكن أن يبقى لنفي العلاقة؟ وإذا كان الشرع يُقدّم هذه الأركان على مجرد التوثيق، فهل من المقبول أن يستمرّ الجدل؟ وهل من العدل أن نُبقي امرأة في دائرة النكران، وقد عاش الناس معها تفاصيل الحكاية من البداية حتى النهاية؟
ما نطلبه ليس أكثر من إحقاق الحق، بردّ الكلمة إلى أهلها، وبأن تُحسم القضية من خلال فتوى شرعية، تنهي هذا القلق العالق، وتُعيد الهيبة إلى العلاقة، وتحفظ لذكرى الفنان الكبير ما تستحقه من وقار.
إن احترامنا لأحكام القضاء راسخ لا يتزعزع، ولكننا في الوقت ذاته نؤمن أن الشرعية، حين تتكامل أركانها، تُصبح ملزمة أخلاقيًا ودينيًا، وقادرة على أن تُكمل ما قد يعجز القانون عن إدراكه. فما لا يُدركه التوثيق، تُدركه الشريعة بنفاذ بصيرتها، ورحمتها، ووعيها بالواقع والمقاصد.
إنها ليست معركة، ولا نزاعًا على تركة، بل جرحٌ في كرامة الذكرى، لا بد أن يُضمد، وكلمةُ حقٍ يجب أن تُقال، لا لينتصر أحد، بل لينتصر الصدق، والوفاء، والحبّ الذي لم يكن يومًا سرًّا، ولا عارًا، بل كان بيتًا قائمًا حتى النهاية.
فلتُنهِ الفتوى هذا اللغط، ولتُطوَ الصفحة بما يليق بأرواحٍ أحبّت، وعاشت، ورحلت. وليبقى العدل رحيمًا، لا قاسيًا، والشرع نصيرًا للحق، لا متفرّجًا عليه. وكفى ما كان من وجع، وكفى ما أُريق من دموع.